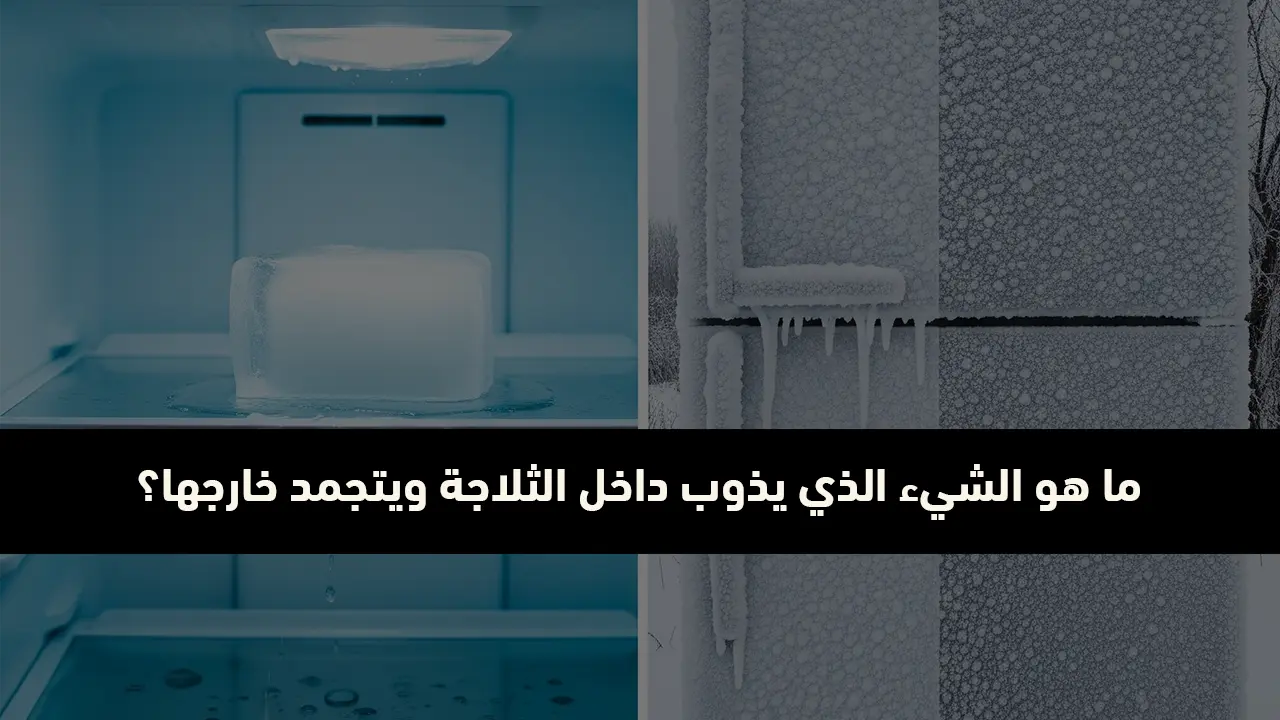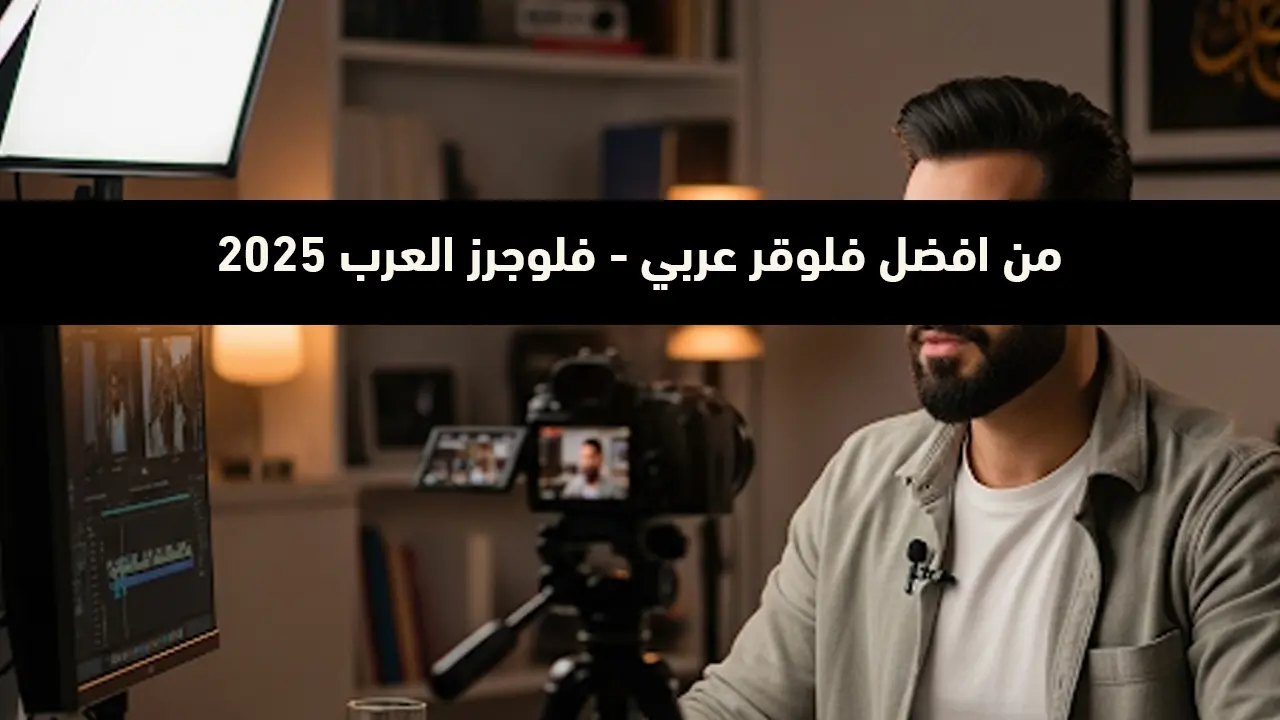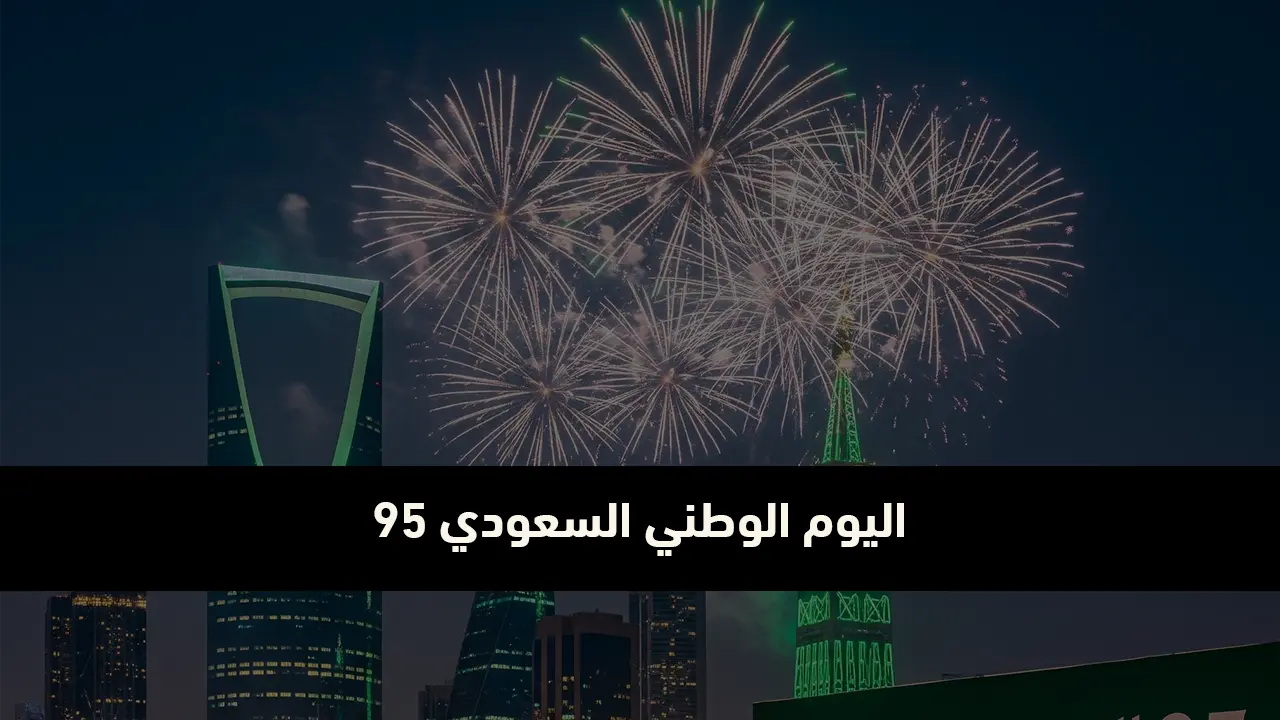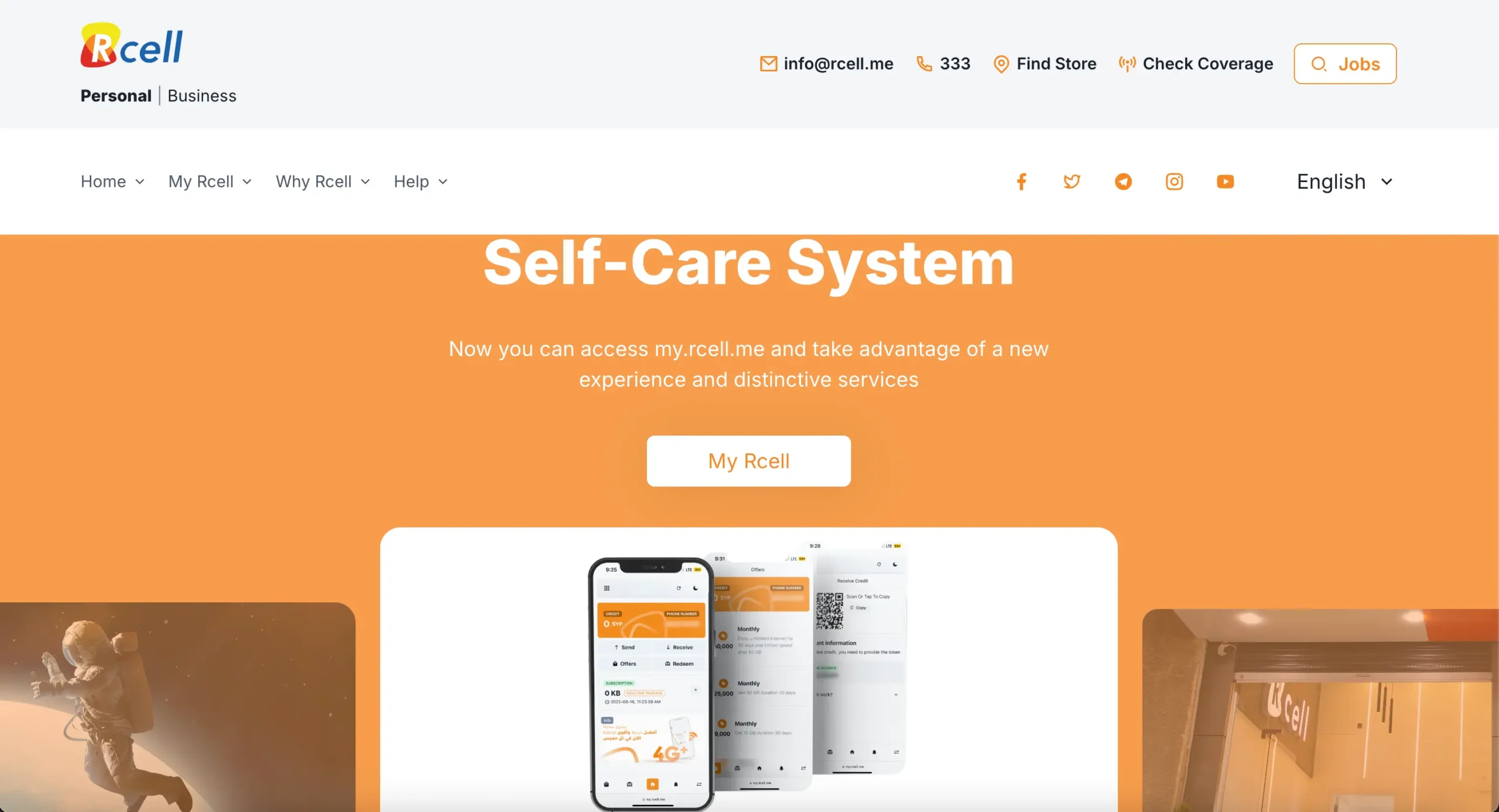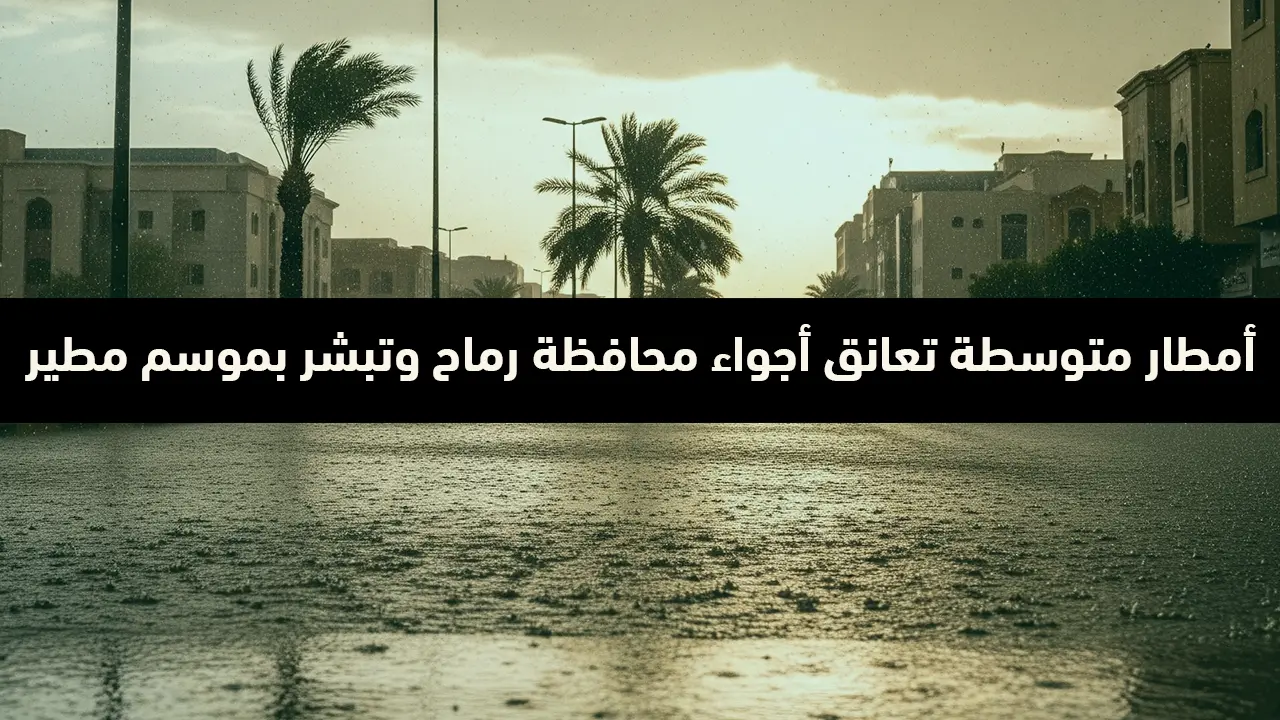جدول التنقل
يُعَدّ تاريخُ شمالِ إفريقيا من أكثر القضايا تعقيداً وتشابكاً في المجالين التاريخي والأنثروبولوجي؛ إذ تختلط فيه الروايةُ الشفوية بالكتابات الكلاسيكية، ويتقاطع فيه النقشُ الحجري مع الشاهدِ الأركيولوجي، وتتنازعُهُ مدارسُ نسبٍ شتى: كنعانية، وحِمْيَرية، وأوروبية، ومتوسطية، وحاميّة.
هذا المقالُ يعيدُ تقديم المادة الغزيرة الواردة في السكربت الأصلي بوصفٍ موسَّع، مرتبٍ زمنياً وموضوعياً، من أقدم العصور حتى بدايات العصر الإسلامي، مع الالتزام الكامل بعدم حذف أي معلومة ومع إعادة تنظيمها فحسب.
سؤالُ الأصول وبواكير الاستيطان
1. من سبق الأمازيغ إلى شمال إفريقيا؟
- العمالقة الكنعانيون والقبائل الحامية: تشير أقدمُ المدونات العربية إلى طرد العمالقة من الجزيرة العربية والشام خلال القرن الـ15 ق.م على يد الملوك السبئيين، فرحل قسمٌ منهم إلى المغرب.
- الهجرات الحامية القديمة: يرى بعضُ المؤرخين أن جماعاتٍ حاميّة ذات أصلٍ كوشي (حبشي-نوبي) سبقت هي الأخرى إلى الساحل الإفريقي الشمالي قبل الموجة الكنعانية.
2. الهجرات اليمنية السبئية
- الموجة الأولى (القرن 12 ق.م): قاد الملك أفريقش بن ذي المنار قبائلَ كنعانية حميرية من اليمن والشام إلى إفريقية، فبنى مدينة «أفريقية» (قرب قرطاج) وأسكن فيها كتامة وصنهاجة وزناتة ولواتة وعهامة.
- الموجة الثانية (القرن 9 ق.م): في عهد الملك ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش جرى تأسيسُ قرطاج وإعادةُ توزيع قبائل حميرية جديدة استقرّت مع الموجة السابقة.
- الموجة الثالثة (القرن 9–8 ق.م): استقدمت سبأ أفواجاً أخرى نحو الساحل الأطلسي وجزر البليار وسردينيا، تعزيزاً لشبكةٍ تجارية عالمية.
نظرياتُ أصل البربر الخمس
- النظرية الكنعانية-الأمازيغية
تردّ الأمازيغ إلى مازيغ بن كنعان بن سام، وقد انتقلت قبائلُه من فلسطين إلى المغرب بعد حروب يشوع بن نون (القرن 12 ق.م). - النظرية الحِمْيَرية-اليمنية
تجعل صنهاجة وكتامة وزناتة ولواتة وعهامة قبائلَ حميرية قحطانية، استوطنت من القرن 12 حتى 9 ق.م. - النظرية الأوروبية
ربطت المدرسةُ الاستعمارية الفرنسية بعضَ الأمازيغ بقبائل كِمَريّة وسلتية؛ لإيجاد أصلٍ «مشترك» يسهِّل دمجهم في المشروع الكولونيالي. - نظرية الجنس المتوسطي
تفترض انتماءَ البربر إلى «سلالة البحر المتوسط»، وهو مفهومٌ أنثروبولوجي يفتقر إلى أسس تاريخية واضحة. - نظرية الأصل الحامي
نشأت أوائل القرن 20 لتُنسبَ الأمازيغ إلى أبناء حام بن نوح، لكنها تصطدم بأن البربر ليسوا زنوجاً سوداً.
مملكةُ قرطاج—سيدةُ المتوسّط والأطلسي
1. التأسيس والأسطورة
- الملكة عليسّة (أليسار): الرواية اليونانية تجعلها أميرةً هاربة من صور أسّست قرطاج عام 814 ق.م.
- الرواية اليمنية: مؤلفاتٌ عربية تَعتبر أن مؤسسَها الحقيقي هو ياسر يهنعم الذي أعاد بناء «قرطا-جنة» وعيّن حكاماً حميريين.
2. البناء والعمارة
- تخطيطٌ دفاعي ثلاثي الأسوار، ومستودعات للفيلة والفرسان والمشاة.
- ميناءٌ عسكري دائري بمدخلٍ وحيدٍ مخفي عن البحر، يعكس عبقريةً هندسية أثارت إعجاب الباحثين الغربيين.
3. الإمبراطورية البونيقية
- امتد نفوذها عبر الساحل من ليبيا إلى المحيط الأطلسي، وشمل جنوب إسبانيا وجزر المتوسط، وسيطرت على طرق القصدير إلى بريطانيا.
- الرحلات البونيقية وصلت –بحسب دلائل أثرية وفينية– إلى سواحل الأميركتين.
4. الحروب البونيقية مع روما
- الأولى (264–241 ق.م): فقدت قرطاج صقلية.
- الثانية (218–201 ق.م): حَمَلات هنيبعل عبر الألب؛ انتصارات تريبيا وترانسيمانيا وكاناي؛ ثم هزيمة زاما وظهور مملكة نوميديا.
- الثالثة (149–146 ق.م): حصار قرطاج وتدميرها الكامل وبيع 600 ألف من سكانها عبيداً.
الممالك البربرية بعد قرطاج
1. نوميديا (202–46 ق.م)
- أسّسها ماسيسينيسا بعد تحالفه مع روما؛ امتدت حدودها إلى مشارف مصر.
- قاوم حفيده يوغرطة الهيمنةَ الرومانية حتى أُسر غدراً.
2. موريطانيا (225 ق.م–40 م)
- عاصمتها وليلي؛ اشتهر ملكُها يوبا الثاني المُثقف الهلنستي.
- تحالفت مع روما ضد قرطاج، ثم صارت مملكة عميلة حتى اغتيال الملك بطليموس، فحُوّلت إلى ولاية رومانية.
العلاقات الثقافية واللغوية
1. الكتابة
- وجود نقوشٍ حميرية وفينيقية بالمسند في قرطاج وأطراف المغرب، منها قبر «الأواش» ومنارةُ ذو المنار وشمر يهرعش.
- أبجدية تيفيناغ اشتُقَّت –بحسب مقارنة عثمان سعدي ويحيى شامل– من حروف المسند والكنعانية؛ عددٌ كبير من رموزها يطابق نظائر يمنية وفينيقية.
2. اللغة الرسمية للدول الأمازيغية الإسلامية
- رغم انتشار اللهجات الأمازيغية، اعتمدت الدولُ الإسلامية الأمازيغية—كالمرابطين وبني مرين—اللغةَ العربية في الدواوين، وضربت دنانيرها بالعربية.
الفتح العربي الإسلامي
1. الحملاتُ الاستكشافية الأُولى
- عمرو بن العاص (21–22 هـ): فتح برقة وطرابلس صُلحاً –بدعم قبائل لواتة– ثم توقف بأمر عمر بن الخطاب.
- الغزو الأوّل الكبير (27 هـ) بقيادة عبد الله بن أبي سرح: مصالة مالية مع البطريق البيزنطي.
2. ولاية معاوية بن حديج ومرحلةُ التثبيت (45–47 هـ)
- افتتح سوسة وجلولاء، وأخلى الرومُ الساحل الشرقي، واختطّ موقعَ القيروان الأول.
3. ولايةُ عقبة بن نافع الأولى والثانية
- سياسةُ العسرة مع القبائل الناقضة؛ توغُّل حتى المحيط الأطلسي.
- خلافه مع الزعيم البربري كسيلة الذي أظهر الإسلام ثم تحالف سراً مع البيزنطيين، فاستُشهد عقبة في تهوذة (63 هـ).
4. أبي المهاجر دينار وسياسةُ الاستمالة
- أكرم كسيلة وقرّبه، فدخلت قبائلُ برانس في الإسلام.
- بعد عزل أبي المهاجر عاد عقبة والـ300 شهيدُ القيروان.
5. زهير بن قيس والقضاء على حركة كسيلة (67 هـ)
- بتكليف عبد الملك بن مروان، هزم جيشَ كسيلة في ممش، واستعاد القيروان لتعود إفريقيا إلى سلطة المسلمين.
البربر بين الرومان والوندال والبيزنطيين
- تَجَنّب البربر الانصهار في الحضارة الرومانية؛ ثوراتهم المتكررة أظهرت رفضَهم للمستعمر الأوروبي.
- قاوموا الوندال (523 م) والبيزنطيين (535–563 م) مقاومةً أفضت إلى انسحاب السكان إلى الجبال والصحارى.
أنماط المعيشة والقبائل الكبرى
| الفئة | السلوك | مواضعُ التمركز |
|---|---|---|
| البِتر (رحّل) | رعيٌ وجِمال | السهول والصحارى |
| البرانس (حضر) | زراعة وصناعة | الهضاب والمدن |
قبائل بارزة
- صنهاجة: حميرية الأصل، قادت الممالك الأمازيغية الإسلامية لاحقاً.
- كتامة: حِمْيَرية، لعبت دوراً حاسماً في دولة الفاطميين.
- زناتة: يمنية؛ انقسمت إلى بطون كثيرة ونافست صنهاجة.
- لواتة: حميرية، استقرت حول برقة وتمتدّ بطونها إلى تونس والجزائر.
المعالم المشتركة بين اليمن والمغرب
- العمارة: أبراجٌ وقلاعٌ جبليّة تشبه ناطحات الحِمْيَر في مرتفعات الأطلس.
- النقوش: انتشار نصوصٍ مسندية في تونس والجزائر يدل على تواصل ثقافي متين.
- التقنيات البحرية: مرافئ قرطاج تشبه مَرافئ بعل-أوام وباران في سبأ.
خاتمة
يكشف التاريخُ المتشابك لشمال إفريقيا عن لوحةٍ فسيفسائية تشكَّلت عبر ثلاثة عصور رئيسة:
- العصر اليمني-الكنعاني الذي أسّس الأرضية الديموغرافية والثقافية.
- العصر القرطاجي الذي بلغ مداه في السيطرة البحرية والتجارة العالمية.
- العصر الإسلامي الذي أعاد توحيد المنطقة دينياً ولغوياً، وأعاد صِلَتها بموطنها الجنوبي.
ومن خلال تتبّع تسلسل الهجرات، ونقوش المسند، وبنية المدن والحصون، واتساق الروايات العربية والغربية، يتبيّن أن الأمازيغ جزءٌ أصيل من النسق العربي-السامِي الواسع، وإنْ تفرّدوا بلسانهم ولهجاتهم وحضارتهم. وأهمُّ ما تؤكده هذه الرحلة الطويلة أن التنوّع في شمال إفريقيا لم يكن قط عاملاً للتشرذم، بل رافعةً للتفاعل الحضاري، وأنّ سرديات «الانقسام» الاستعمارية سقطت أمام قوة الترابط التاريخي بين ضفّتي الصحراء الكبرى وضفّتي البحر المتوسط.